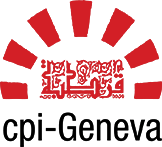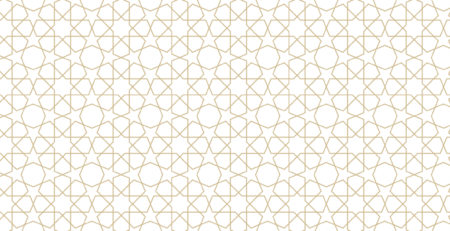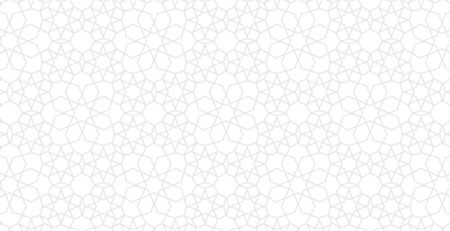في الذكرى العاشرة منذ انطلاق شرارة الثورة التونسية

حوار مع ماهر الزغلامي، باحث علم الاجتماع
في الذكرى العاشرة منذ انطلاق شرارة الثورة التونسية ما تقييمك لما تحقق؟
الثورة لم تكتمل والثورة المضادة لم تنتصر.
كثيراً ما يجيب الفاعلون السياسيون عن هذا السؤال، بكون الثورة حققت مكسب الحرية وهو ثابت ولم يعد من الممكن فقدانه. في الحقيقة لا أدري على ما يستند الفاعلون في هذه الإجابات القطعية! في تقدري أن ما تحقق من نصاب الحرية جلّي ومطمئن نسبياً، غير أنّ إمكانيات الارتكاس ممكنة نظرياً ولائحة عمليّاً.
مع ذلك يمكن القول بشيء من التجوّز أن مناخ الحريّة والعمل السياسي ضمن مربع الديمقراطية هو المكسب الأهم، مقارنة بالعجز الاقتصادي وعدم استكمال الديمقراطية لشرطها الاقتصادي. -هكذا يجيب الفاعلون أيضا-، أتفق مع ذلك غير أن سلسلة التبعات للثورة غير المكتملة لن تتوقف عند التدهور الاقتصادي، بل سيمتد جثومها على الجسم الاجتماعي.
ما مزايا تونس مقارنة بباقي دول الربيع في المنطقة حيث كانت النتيجة أكثر عنفا؟
تحليليا، هناك عديد الفرضيات الممكنة للإجابة. منها فعل السبق، فلنتخيل لو كانت تونس ثلاث بلدان الحراك الثوري في العالم العربي مثلا، كيف ستكون النتيجة؟!
هناك فرضية أخرى، لا أدري مدى صلاحيتها، متعلقة بضعف الإمكانيات: ضعف الإمكانيات العسكرية، ضعف الثروات الطبيعية “نسبيا” أو مقارنة بليبيا مثلا، تونس أيضاً لا تمثل خطراً متاخماً لاسرائيل مثل سوريا ومصر، إلخ.
مع ذلك، يجب ألاّ نغفل، الدور الحاسم المتمثل في القدرة على استيعاب ثقافة الدولة لدى الفاعلين السياسيين حينها – بصرف النظر عن تقييمهم – وهي الثقافة الّتي تهرأت على مدى السنوات العشر لدى نفس الفاعلين. والأخطر هو دخول فاعلين جدد من خارج الحقل السياسي لذات الحقل ممّا أفقده عقلانيته، وعادت التجربة مهددة بالنسف مرّة أخرى.
كيف تقييم الطريقة التي تدير بها النخب السياسية خلافاتها الإيديولوجية؟
انتهت الأيديولوجيا وبقي الصراع.
النخب الممارسة للفعل السياسي اليوم، سواءً في الحكم أو في المعارضة، فاقدة للذاكرة الأيديولوجية، لم يبق من الأيديولوجيا غير الاسم الموظّف في صراعات التموقع والمصالح. إذ تستدعى دائما ورقة ضغط، وأتوقع أنها ستكون الورقة الأبرز في صراع التأويل الّذي سيفتح على مصراعيه عند تركيز المحكمة الدستورية، في علاقة بحرية الضمير وحماية المقدسات ورعاية الشأن الديني والحريات الفردية وما إلى ذلك. لا من باب البحث الحق عن عقد ثقافي اجتماعي يوفر للناس أماناً روحيّا ويهديهم سبل الوعي الحضاري والثقافي، بل من باب المقاولة السياسية ذات الانعكاسات المعمقة للشروخ الاجتماعية.
ومن أزمات الفعل السياسي الكبرى اليوم أنه فعل مفرغ من المعنى. لم يعد من معنى للمعنى في زمن السياسي. أرى ذلك نتيجة طبيعية لضمور الخيال السياسي والكسل على التأصيل الفكري للمشاريع السياسية بمختلف اتجاهاتها -يعزو الفاعلون ذلك عادةً لضرورة التخصص الخبري- وكأن التخصص والخبرة يتناقضان مع التفكير!
على ذلك يصبح السؤال الأسلم، هو كيف تدير النخب السياسية صراعاتها؟
والجواب هو: “بالمقاولة السياسية”. تحول الحقل السياسي لحقل مقاولات، بحكم تراجع ثقافة الدولة لدى الفاعلين السياسيين “الكلاسيكيين” وبفعل غزو الفاعلين الجدد من خارج الحقل السياسي واحتلالهم لمجالات هذا الحقل وإدارته بقواعد من غير جنسه.
لماذا فشلت جهود الثورة المضادة في تخريب الانتقال الديمقراطي في تونس؟
كما أسلفت هي لم تنجح بعد لكنها أيضاً لم تفشل بعد.
إحدى المفارقات الغريبة، كون الثورة المضادة متمثلة في التعبيرة السياسية الرافضة للاعتراف بالثورة من حيث وجودها أصلا، فضلا عن الاعتراف بشرعيتها، هي من آخر معاقل الفعل السياسي “المُعقلن” وإن كان الأمر متعلقاً بالدعوة للاستبداد وربما بممارسته. ما يظهر في الصورة، بلا ريب، هو شعبوية الخطاب ولكن من وراء ذلك “مَكِينِة فعل سياسي كلاسيكية” ربما هي نفسها “مكينة حزب التجمع المنحل أو هي الاستلهام الأقرب لذلك”. هذه التعبيرة، بصرف النظر عن خطابها الشعبوي، مستوعبة جيّداً لقواعد الفعل السياسي (وإن استعملت أرذلها)، مدركة لرقعة الفاعلين المحليين والدوليين، لها استراتيجيات ذاتية متوافقة مع محاور خارجية متدخلة، لها امتداد في مفاصل الإدارة إلخ. كلّ ذلك يظهر أحياناُ في حرفية صياغة بعض الملفات المقدمة في مجلس نواب الشعب.
في المقابل نجد من القوى المتكلمة باسم الثورة والمدافعة عنها، تعبيرات شعبوية في خطابها، شعبوية في جوهرها. بمعنى أنها من ناحية أولى دخيلة على الفعل السياسي ومن ناحية ثانية “لا مَكِينَة لها” ومن ناحية ثالثة لا استراتيجية لها غير تجاوزها لكل القواعد المعقلنة للحقل السياسي، ممّا يكسبها قبولاً لدى جزء من القاعدة الانتخابية.
الأمر فعلاً معقّد.
هل الأزمة السياسية الراهنة بين الرئاسة والحكومة والأحزاب الداعمة لها في البرلمان مظهر صحي للتنافس السياسي أم اعرض قصور في الدستور؟
بل هي باختصار أبرج تجليات اختلال معايير الحقل السياسي كما بيناها سابقا، وأوضح أسباب الفشل الاقتصادي المتراكم وتداعياته الاجتماعية. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوز هذه الأزمة دون التأسيس لميثاق سياسيّ جديد.
هل هناك عمل جدي على مستوى السياسات العمومية من اجل معالجة مسائل التنمية اللامتوازنة والتهميش والإقصاء الاجتماعي والسياسي التي كانت وقود الثورة قبل عقد؟
في أفريل 2020، عقد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وجزء من فريقه الحكومي حينها، اجتماعاً مطولاً جمع فيه ثلّة من الخبراء لتدارس واقع الفئات الهشة والتداعيات الواقعة والممكنة لأزمة الكوفيد 19 عليها. كنت من بين الحاضرين ورفعت توصية سياسية مفادها إحداث فريق قار داخل رئاسة الحكومة لتحليل الاستبعاد الاجتماعي وبناء سياسات عمومية إدماجية (وكنت مستحضراً المثال البريطاني).
كيفية تفاعل رئيس الحكومة السابق ومن معه، أوحت لي شخصيّاً بإمكان عمل جدّي ضمن ذلك الفريق. وقد سلكت التوصية طريقها فعلاً، لو لا ارتجاج الحقل السياسي مرّة أخرى. وتناحر مختلف الأطراف، وتعطّل بوصلة ثقافة الدولة الّذي أودى أخيراً لإسقاط الحكومة.
مع ذلك تمّ تشكيل فريق رباعي يعنى بإنتاج تقرير حول الهوامش ودلالات الاستبعاد والسياسيات الإدماجية. يشتغل بالإمكانيات الدنيا في ظلّ عدم استقرار المشهد السياسي.
عجز الدولة ومؤسساتها اليوم، وفي ظل الحالة السياسية الراهنة، عن إنتاج معرفة دقيقة حول الفئات الاجتماعية الّتي همشت على مدى عقود. وعدم القدرة على وضع سياسات عمومية ملحقة ببرامج أفقية واستراتيجيات تنزيل قطاعية، يحدث مناطق فراغ شاسعة. تتسابق على احتكارها “الطوائف البحثية” غير المعتنية بالحقل البحثي بقدر انغماسها أيضا في المقاولة السياسية، محاولة “احتكار التفسير” للأزمات الاجتماعية وتوظيفها. للتحول بذلك من مرجعية علمية، محكّمة ومفسرة، إلى طوائف بحثية تشتغل حسب الطلب باعتبار احتكارها للتفسير ومحاولة التكلم باسم الفئات الهشّة.
بلغنا عجزا ثلاثي الأبعاد، عقل الدولة وعقل الخبرة العلمية وعقل المجتمع المدني، كلها مرتهنة للفعل السياسي المفرغ من المعنى والموسوم بالمقاولة، ولم يجلو فرج بعد.