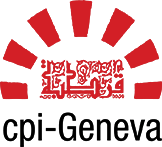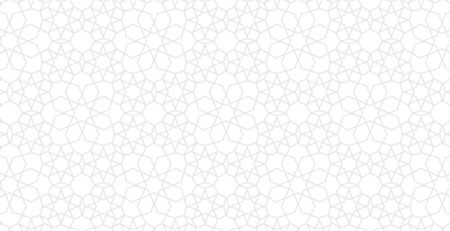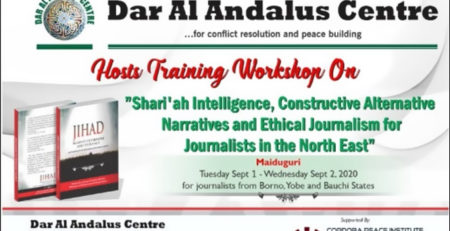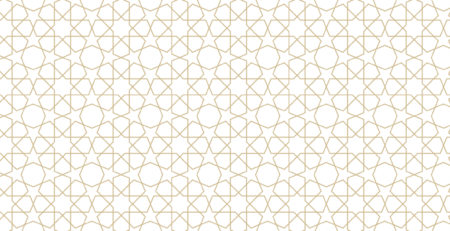العنف القبلي في الساحل: الدول في مواجهة تحدي الهويات

منذ العشرية الأولى لحقبة الألفين، أدى استفحال ظاهرة العنف في العديد من الدول في منطقة الساحل، كما هو الحال بشكل متواصل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد، وبشكل اقل حدة في ساحل العاج والكاميرون وموريتانيا، تغذيها جماعات مسلحة تستدعي البعد الديني باسم “الجهاد” في تبريراتها، إلى دخول المنطقة في دوامة جديدة تضع الوئام الاجتماعي في الدول المستهدفة أمام امتحان عصيب. فإضافة إلى أن ذلك العنف يعيد طرح العديد من الأسئلة حول طبيعة العناصر المؤسسة للعقد الاجتماعي في تلك البلدان من خلال استدعاء البعد الديني ذاك، فإن نشاط الكثير من الفاعلين، تحت يافطة هوياتية ضيقة أو باسم مجموعات عرقية وقبائل، يعقد الوضع أكثر.
بقلم عبد الله باه
وباتساع رقعته إلى مناطق خارج الحدود المعروفة تقليديا للساحل، أصبح العنف وسيلة لتصفية الحسابات بين المجموعات والإثنيات، بحيث يؤجج الخلافات القديمة إما بين المجموعات المختلفة فيما بينها أو داخل المجموعة الواحدة. ولذلك الوضع تأثير واضح، خاصة على المجموعات العرقية العابرة للحدود، أي تلك التي تقطن، غالبا، على المناطق الحدودية، مع عدم إمكانية واضحة لتلك الدول في تسيير شؤونها؛ مما سهل تحول الفاعلين في ذلك العنف إلى حملة لمطالب تعبر عن استياء تلك المجموعات من وضعيات تهميش وسوء معاملة واقعية في بعض الأحيان أو متصورة في أحيان أخرى. وبذلك يكون السعي إلى خلق واقع سياسي جديد في ذلك الفضاء حلما يراود المنعشين غير الظاهرين لذلك العنف، مما يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار الدول المستهدفة.
سنتناول، من خلال هذا المقال، لثلاثة محاور يتمحور أولها (1) حول مسألة “الجهاد” وتوظيف المجموعات العرقية في السياق المالي ثم نشرح قضية تهييج المجموعات القبلية (2) قبل الحديث عن ممانعة المجموعات القبلية القاطنة في المناطق الحدودية (3) ونختم بمقاربات لمحاولة الإجابة على إشكالية ملحة تتمثل في “أية مقاربة لمواجهة تحدي الهويات الضيقة” في منطقة الساحل؟
1. “الجهاد” وتوظيف المجموعات العرقية
منذ استقرار عناصرها الأولى في الشمال المالي مع بداية سنة 2003 عبر مجموعة الملثمين بقيادة المختار بلمختار، بإيعاز من الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي ستتحول فيما بعد إلى “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، عملت المجموعات “الجهادية” إلى استمالة عطف السكان المحليين. وصادف ذلك الاستعطاف هوي ساكنة المناطق لكونها معزولة في الهامش ومنسية من قبل الدولة. وسرعان ما أطر “الجهاديون” المناطق بمليء الفراغ الذي تركته الدولة، عاملين على تقويض جهود التعبئة والتأطير التي كانت تتكفل بها عناصر حركات التمرد السابقة على الجهاديين. ومن ذلك، سيطرة “الجهاديين” على مسالك مرور القوافل المحملة بالبضائع المحظورة عبر الصحراء (المخدرات، الأسلحة والمهاجرين السريين…الخ)، مضطلعين بذلك بمهمة تنظيم الاقتصاد المحلي في المنطقة. كما وفروا نوعا من الخدمات الأساسية بحفر نقاط ماء وتشييد مراكز أولية للصحة كانوا يؤمنون تزويدها بالأدوية الأساسية. وهذا، بحد ذاته، شيء معتبر للغاية بالنسبة لسكان رحل مهملون ومتروكون في مواجهة واقع لا قبل لهم به. كما أسس “الجهاديون” نظاما للتعليم في الحواضر البدوية يقوم على تدريس علوم الدين بالدرجة الأولى.
وبحكم توظيفهم للمئات من الشباب العاطل في خدمات مختلفة، ساهم “الجهاديون” في خلق اقتصاد ريعي يقوم على الجريمة، مقوضين بمداخيله أسس العلاقات الداخلية بين المجموعات والتي كانت تتسم بالدقة في التنظيم من حيث التراتبية التقليدية.
وبالعزف على الدين الحساس، يغذيه الشعور الجارف بالغبن والتهميش لدي المجموعات المحلية في تلك التخوم، وضع الجهاديون مسألة العقيدة في مقدمة الأوليات بالدعوة إلى “العودة إلى الروح الإسلامية السليمة”. وعلى هذا المرتكز الجديد، تمكنوا من خلق واجهات جديدة بين المجموعات وتأطيرها لكي تكون وسيطا مقبولا لدي القبائل، مع اعتبار الإسلام أول ركيزة للهوية الجامعة لتلك القبائل. وبإسناد ذلك المرتكز إلى الفكر السلفي الوهابي، برز، وبقوة، نقد تعاطي الثلة المثقفة مع العقيدة، ومن خلال ذلك تم التنظير لتجريم العلاقة “الكافرة” بين الدولة والدين. وتحول ذلك النقد، تدريجيا، الي رفض منهجي للدولة في شكلها الجمهوري والعلماني كما ترتب له وتنظمه الدساتير.
ولم تكن أحداث سنة 2012 المتسارعة بسبب انهيار النظام الليبي سوي تتويجا لوضعية احتقان طويل الأمد في المناطق الشمالية من مالي. فكانت تلك الأحداث مناسبة لمختلف الحركات السلفية “الجهادية” وحلفائها من الحركات القومية كالحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها، مناسبة لتجربة رؤيتها السياسية ميدانيا، رغم الخلاف حول الأهداف بين الطرفين. فبينما كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركات الدائرة في فلكها تطالب باستقلال المنطقة الشمالية من مالي تحت اسم أزواد، تضم ولايات كيدال، تمبكتو، غاوو وأجزاء من ولاية موبتي، مع ساكنة من العرب والطوارق والسونغاي. وفي المقابل، كانت الحركات “الجهادية” ذات المرجعية السلفية، خاصة أنصار الدين ببعد المحلي، تنادي بالإبقاء على الكيان المالي موحدا ولكن بفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة أنحائه. وفي هذه النقطة بالذات، حدث الاصطدام بين المشروعين، حيث تنطلق الحركة الوطنية لتحرير أزواد من منظور علماني سرعان ما جابهته التيارات الجهادية بعنف، مما عجل من اندحارها أمام مقاتلي القاعدة وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وفي زمن قصير للغاية، خلت الساحة للـ «الجهاديين” حتى التدخل الفرنسي الذي شتت صفوفهم وخلص المنطقة من سيطرتهم المباشرة.
2. تهييج المجموعات القبلية
إبان احتلال الشمال، شهدت كافة المنطقة التي وقعت تحت سيطرة الجماعات المسلحة حالة من الاضطرابات الأمنية المعقدة. فحملت حالات النهب المتكررة، خاصة للمواشي، العديد من القبائل ومجموعات الرعاة إلى اقتناء السلاح. وبتأطير من مقاتلي حركة التوحيد والجهاد، تم تدريب الرعاة من أبناء الفلان والدوغون والسونغاي في مالي على التعامل مع السلاح للدفاع عن أنفسهم ومواشيهم. ولاحقا، سيفتح المجال خاصة أمام الرعاة الفلان من النيجر وبوركينا فاسو لنفس الغرض. وسرعان ما تحولت تلك المجموعات الي وحدات للدفاع الذاتي لمنع تعرض مواشيهم للنهب. وبعد التدخل الفرنسي في شهر يناير 2013، تم دمج غالبية أعضاء تلك المجموعات في عداد مقاتلي المجموعات المسلحة “الجهادية”. وسيشكل إنشاء كتيبة ماسينا لأنصار الدين في كونا (وسط مالي) سنة 2012، بقيادة محمدون سادا باري (المعروف بمحمدون كوفا)، رأس حربة للهجوم “الجهادي” المرتب نحو الجنوب صوب باماكو. كما سيشكل، في نفس الوقت، بداية لتجنيد واسع للسود المحليين في معركة “الجهاد” الذي ظل منحصرا، حينئذ، على أبناء المجموعات القبلية المنحدرة من الشمال.
بدأت كتيبة ماسينا عملياتها العنيفة في مايو 2015 في وسط مالي بتدمير ضريح الشيخ آمادو بن آمادو مؤسس امبراطورية ماسينا الإسلامية. وواصل عناصر الكتيبة، تباعا، تنفيذ عمليات عنف عشوائية ضد المدنيين مستهدفين، دون تمييز، كافة سكان المنطقة الوسطي من البلد. وكنتيجة لذلك، بدأت إمارة الشيطنة تطبع العلاقات بين أكبر مجموعتان تقطنان المنطقة: الفلان والدوغون. وسرعان ما وجدت المجموعتان نفسيهما في دوامة عنف “جهادي” لا وجه له، أتى لينضاف إلى العديد من المشاكل المتراكمة دون حل بين المجموعات.
وكانت الصراعات حول استغلال المصادر الطبيعية في محيط يجتاحه الجفاف، مجففا العديد من منابع تلك المصادر، مغذيا أساسيا للعنف الذي أخذ، في بداياته، شكل تصفيات مركزة تستهدف الأعيان قبل أن يتحول، سنة 2018، الي مذابح دامية أودت بحياة أكثر من 2000 شخصا وأدت إلى هروب آلاف النازحين. كما ان ظهور جماعات مسلحة جديدة تحت يافطة عرقية كميليشيا “دان نا امباسوغو” (للقناصين الدوغون) وحركة خلاص الساحل (العلمانيون الفلان)، إضافة الي ميليشيات طارقية أخرى كالغاتيا (الإمغاد) وحركة خلاص أزواد الناشطة في الحدود مع كل من بوركينا فاسو والنيجر، زاد الوضع صعوبة وتعقيدا. وبالتوازن مع ذلك، بدأت حمي متسارعة بين المجموعات والقبائل للسباق على التسلح، حيث تحاول كل واحدة حيازة السبق لضمان امنها مع غياب الدولة وعجزها البين عن القيام بدورها. والأخطر من ذلك أن بعض الأجنحة النافذة داخل الأنظمة في المنطقة تؤجج ذلك العنف سياسيا وامنيا باستغلال التجاذبات العرقية المحلية في أجندات سياسوية غامضة، تؤثر بشكل سلبي للغاية على مسارات الوضع في تلك البلدان. ويعتبر الوضع، كما يتراءى من خلال الحالة المالية، هو نفسه السائد في بلدين على الأقل، في المنطقة هما النيجر وبوركينا فاسو.
ففي بوركينا فاسو، أدى الوضع الأمني الخطير في شمال البلاد وتحديدا في ولاية السوم وشرقها في ولاية فادا انغورما، الي ميلاد مليشيا محلية، “الكوغلويغو” (حراس الغابة) التي كانت خلف نشوب اعمال عنف عرقية خطيرة. ففي شهر يناير سنة 2019، ادي اغتيال ثلاثة اشخاص على ايدي افراد يفترض انهم “جهاديون”، الي اعمال عنف خلفت 200 قتيلا، كلهم من قبائل الفلان في مركز ييرغو في منطقة بارسالوغو شمال غربي البلاد. ومنذ تلك الاحداث، ما زال المراقبون يسجلون استمرار اعمال تصفية عرقية ضد الفلان. فإضافة الي مليشيات الكولويغو (المحسوبة على قبائل الموسي)، تتجه أصابع الاتهام الي الجيش البوركينابي والذي سرعان ما تنفي عنه الحكومة تلك التهمة كلما استجوبت بشأنها.
ومهما يكن، فإنه طالما لم يعمد الي التفكير الجاد حول أساليب جديدة وناجعة لوضع حد للعنف المستفحل، يأخذ بعين الاعتبار مطالب المجموعات الهشة، فإن منطقة الساحل ستتحول الي مدخنة ساخنة لعنف لن يتوقف، مما سيحولها الي صومال جديدة في افريقيا. وعلى الشركاء الدوليين، خاصة القوي الحاضرة ميدانا بقواتها العسكرية، ان لا تظل في موقف المتفرج امام عمليات إبادة جماعية تهدد وجود تلك الدول بشكل عميق.
3. ممانعة المجموعات القبلية القاطنة في المناطق الحدودية
رغم غياب الدولة في الساحات الساخنة التي تنشط فيها الجماعات المتطرفة العنيفة، طورت المجموعات السكانية القاطنة على المناطق الحدودية نوعا من الممانعة مكنها من التعلق بأمل في تحسن الوضع. فهذه المجموعات التي تعيش في الأطراف، بعيدا عن المركز ومهملة من قبله، في غالبها رعوية وعصية على الانفتاح على العالم العصري بحكم نمط حياتها. بحكم بعدها عن “الدولة”، فإنها لا تلج الي المرافق والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية إلا في نادر الأحوال وبشق الانفس.
في الغالب، تزاول تلك المجموعات أنشطة اقتصادية تقليدية كالرعي والزراعة الموسمية والصيد البحري والقنص والتجارة غير المصنفة. وبحكم كونها تعيش على تخوم دول عديدة، تعتبر تلك المجموعات نفسها منتمية الي كل واحدة من تلك الدول، في جهل (او تجاهل تام) للحدود السياسية (كما هو الحال بالنسبة للعرب المحليين، والفلان، والطوارق، والكانوري والهوسا…الخ). كما انه غالبا ما تفتقر تلك المجموعات الي اطر ومثقفين اكفاء يستطيعون الحديث باسمها والتكفل بمهمة توصيل مطالبها.
وتمكنت مختلف المجموعات والحركات المسلحة كنصرة الإسلام والمسلمين والقاعدة وبوكو حرام والدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وغيرها من استغلال كل تلك العناصر واستقطاب الكثير من أبناء تلك المجموعات فتسللت الي الكيانات المحلية وتوغلت فيها وجعلتها بمعزل عن الدولة وفي مواجهة معها. كما استغلت نفوذها من اجل خلق فجوة أدت الي التباعد بين المجموعات على أساس ديني او عرقي، خدمة لمصالحها واجندتها الخاصة.
وامام “العسكرة” الواسعة للعديد من القبائل والإثنيات والشيطنة المربكة لبعضها البعض، انهار العديد من مقومات الممانعة التي كان يعول عليها الكثيرون، كما عليه الحال وسط مالي حيث تحدث مذابح واسعة بين الفلان والدوغون. ويبدو الوضع هو نفسه في الحدود الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فمذبحة ييرغو الأخيرة في بوركينا فاسو احدثت شرخا عميقا بين السكان الفلان وبقية المكونات الوطنية الأخرى من جهة وبينها وبين الدولة من جهة اخري. ولا يبدو الوضع أحسن في المناطق الواقعة تحت سطوة العنف الذي تمارسه جماعة بوكو حرام (النيجر، نيجيريا واتشاد). وفي كل تلك المناطق، يجد السكان المدنيون أنفسهم بين مطرقة “الإرهاب” وسندان عمليات “مكافحة الإرهاب”!
4. أية مقاربة لمواجهة تحدي الهويات الضيقة؟
غالبا ما تكون استجابة الدول غير ملائمة لطبيعة الوضع مما يدفع بالعديد من الشباب للارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة العنيفة او بالانخراط في صفوف مليشيات الدفاع الذاتي القبلية، مما يقوي الشعور بالانتماء الضيق لمجموعة عرقية او إثنية على حساب عقلية الانفتاح ويقوض إمكانيات القبول بالآخر ويحول دون إمكانية اللجوء الي حوارات محلية واسعة للقضاء على مكامن الخلافات، رغم انه يوجد في المنطقة ارث تاريخي قديم للآليات التقليدية لفض النزاعات.
كما ان المقاربة الأمنية الخالصة التي برهنت على عدم نجاعتها في كل المناطق، خاصة في مالي (في السنوات 90 و2000 و2013 و2018) وفي نيجريا وغيرها، لا تتيح لشباب تلك المجموعات (المتهمين سلفا) أية إمكانية أخرى غير اللجوء إلى الجماعات المتطرفة العنيفة، مما يضعف من أسباب ولاء السكان للدولة.
والأدهى من ذلك، إن بعض الفاعلين في تلك المجموعات تعرض مساعيها الحميدة من اجل السلام، تعبيرا عن استعدادها للعمل مع الدولة والتعامل مع الحكومات، غير أنها تواجه، أحيانا، بكثير من اللامبالاة؛ حيث تكلف الحكومات قادة جيوشها وممثلي الأمن بالتعامل معهم، دون أن يكون أولئك القادة على المستوي المطلوب ولا يمتلكون الوسائل والآليات المطلوبة لتسيير ذلك بشكل ناجع.
وفي كل الأحوال، يجب على الدول، إن هي أرادت احتواء العنف القبلي أو العرقي المستفحل تحت عباءة التطرف العنيف ونسف أسس الخطاب الديني المتطرف العنيف:
- ضمان توفير واستمرارية الخدمات الأساسية، خاصة التعليم، في أزمنة الأزمات الأمنية في مناطق الصراع؛
- تشجيع ودعم آليات المناعة الاقتصادية للسكان عبر توفير الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية (الموارد الزراعية والغلال وغيرها)؛
- خلق قنوات للتواصل والتحسيس مع حملة السلاح من أبناء المجموعات المحلية من اجل ثنيهم عن المساس بالسكان المدنيين العزل من المجموعات المجاورة ومحاربة ظاهرة عدم العقاب؛
- تشجيع القادة التقليديين والمشيخة الدينية المحلية على ترقية الوئام الاجتماعي والتفاهم بين المجموعات رغم استفحال ظاهرة مليشيات الدفاع الذاتي في أوساطها.
كما يتعين رفض ومعاقبة الخطاب الطائفي العنيف وزرع مقومات الثقة بين كافة المجموعات من خلال:
- الاستماع إلى القادة التقليديين المحليين والمشيخة الدينية وممثلي منظمات المجتمع المدني المحلي والشباب؛
- مراقبة تصرفات أعضاء القوات المسلحة وأجهزة الأمن في الميدان، خاصة عند مباشرتها لعمليات بسط الأمن في المناطق المعزولة (تأمين السكان المدنيين، تفادي الشيطنة والحكم المسبق، احترام حقوق الأسرى بالنسبة للمقاتلين الذين يتم القبض عليهم، الخ…)؛
- اللجوء إلى مقاربة شمولية تضمن إشراك سكان المناطق الحدودية الأكثر هشاشة في تصور وصياغة القرارات المتعلقة بمناطقهم وتنفيذها؛
- تشجيع الاعتماد على مقاربات ترشيد الخلاف بين السكان من خلال حملهم على الحوار من خلال الممارسة بالتركيز على المهم الجامع (التعليم، الصحة، الولوج الي الخدمات، وتقاسم الثروات الطبيعية الخ…)؛
- تشجيع المبادرات المحلية الرامية إلى إقناع أعضاء المجموعات المحلية، خاصة الشباب، بعدم الانجراف وراء الجماعات المتطرفة العنيفة، بما فيها تلك التي تدور في فلك التنظيمات القبلية المسلحة.